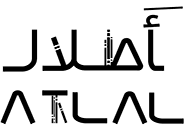الفنون والمعارف في الدولة الأموية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ..
اعتاد الناس في هذا الزمن على أن يصنِّفوا الحياة من حولهم، إما أبيض وإما أسود، إما أن تكون إنساناً صالحاً وإما أن تكون إنساناً فاسداً، هكذا فهموا الحياة من حولهم وهكذا يفضلوا أن يتعاملوا معها، حتى إن كثيراً منهم غرق في نظريات لا معنى لها فضلاً عن أن يكون عليها دليل أصلاً، ومما نتج عن هذه الحالة ما نعانيه اليوم من محاولة قولبة المؤرخين والأحداث التاريخية في قوالب معينة يحددها عامة الناس، فأنت إما أن تكون مع الأمويين أو ضدهم، ولا يمكن أن تكون موضوعياً تذكر السلبيات وتعترف بها وتذكر الإيجابيات وتشيد بها.
ومما أحب أن ألفت النظر إليه في هذه المقالة بعض الجوانب الثقافية والمعرفية والفنية في دولة بني أمية في الشام والتي قد يستغرب البعض عند سماعها لأول مرة، فكثير منا يعرف الجامع الأموي على سبيل المثال ويعرف أن قُبة النسر لما بُنيت لأول مرة كانت مرتفعة عن الشام كلها حتى قال ابن جبير: “ومن أي جهة استقبلت البلد ترى القبة في الهواء منيفة على كل علو، كأنها معلقة من الجو”.
ولقد توارثت الأجيال هيبة في القلوب لهذه القُبة الكبيرة حتى إنك تجد في سير بعض رجالات العلم أنهم يكتبون: “وكان كُرسيه تحت قُبة النسر” توثيقاً لهذا الحدث الذي كان ولم يزل حدثاً فاصلاً في تاريخ الشام والعرب والمسلمين وكذلك قُبة الصخرة التي بناها عبدالملك بن مروان وما يلحقها إلى اليوم من قداسة لا تخفى على أحد.
لن أطيل في سرد المعروف من الفنون لكن وعلى سبيل الحكاية فقد ذكروا أخباراً في اهتمام بعض ولاة بني أمية بالغناء والموسيقى يتضارب بعضها مع بعض، ومنها أن طويس – المغني – كان يغني بين يدي بعض ولاة الأمويين ويكرمونه بما يستطيعون ويستحسنون منه ذلك، وقيل بل إن مروان بن الحكم أو أخاه يحيى بن الحكم في فترة ولايتهما للمدينة المنورة أهدرا دم طويس وجعلا لمن يأتي به من الناس 300 دينار كمكافأة، مما يجعلنا نقف أمام مشهدين متناقضين، قد نفهم منهما أن الأمويين لم يكونوا يتعاملون مع الغناء باعتباره فناً يحمل قيمة ثقافية محددة وإنما باعتباره حديثاً من أحاديث الناس والحواري.
وعلى سبيل الحكاية أيضاً فطويس هذا هو الذي يضرب به المثل في الشؤم، فيقال: أشأم من طويس، قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: “لأنه ولد في اليوم الذي قبض فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطم في اليوم الذي قُبض فيه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وختن في اليوم الذي استشهد فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل بلغ الحلم في ذلك اليوم، وتزوج في اليوم الذي استشهد فيه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وولد له مولود في اليوم الذي استشهد فيه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل بل في يوم استشهد فيه سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما، فلذلك تشاءموا به. وهذا من عجائب الاتفاقات”.
وعوداً على موضوعنا فإنه يمكننا التدليل على ما ذكرنا بقصة سعيد بن مسجح مع عبدالملك بن مروان بالإضافة لكثير من الأسماء التي حدثت لها قصص مشابهة وكانت تتردد في تلك الأيام، كميلاء والتي هي أول مغنية عُرفت في العصر الأموي وكان لها كاريزما خاصة، حتى إن طويس كان كالتلميذ عندها، لكن قيل إن والي المدينة المنورة الأموي حاول منعها من الغناء رغم افتتان أهل الحجاز عموماً بغنائها والقصة شهيرة ومعروفة، وكان مذهب أهل الحجاز – علمائهم وعوامهم – استلطاف الآلات والأغاني بخلاف غيرهم من أهل المدن والمناطق الأخرى كالشام والعراق، وكان أهل الحجاز يفتخرون بذلك أصلاً فلا يمكننا تحليل بعض هذه الأحداث على أنها أثر أموي ثقافي أو فني، لكن يمكننا القول إن هذا الفن على وجه التحديد كان كالشعر، يرتفع سوقه ويهبط مع كل خليفة جديد، فأيام الوليد بن يزيد ليست كأيام عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه مثلاً.
ورغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن الأمويين كانوا يتعمدون نشر ثقافة الغناء في الحجاز ليثبّطوا أهله عن الوثوب عليهم والمطالبة بالخلافة الراشدة مرة أخرى، إلا أن هذه الادعاءات ليس لها وجه ولا عليها دليل ولا تناسب السياق التاريخي في ذلك الزمن.
أما عن الثقافة والعلوم فقد كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صاحب معرفة دينية ودنيوية حتى إنه سبق عصره في السياسة والنظر لكنا للأسف لا نجد أثر هذه المعارف على المجتمع الأموي والعربي في ذلك الوقت ولا نجدها حتى في ابنه يزيد، الذي أخذته الأشعار والقصص عن حقيقة المعرفة وكان من أشهر القصائد التي تُنسب إليه:
خذوا بدمي ذات الوشاح فإنني
رأيتُ بعيني في أناملها دمي
إلى آخر الأبيات الشهيرة والتي لا تزال تُلقى على الأسماع إلى اليوم، وهذا إن دل فإنما يدل على غزارة المعرفة وصدق الإحساس وعُمقه في شخصية يزيد، لكن المعرفة والإحساس والعاطفة عند يزيد بن معاوية توجهت في اتجاهات لم تُحمد عُقباها فيما بعد.
وكان عبدالملك بن مروان فقيهاً حتى ولي الخلافة فأغلق المصحف الشريف وقال: هذا آخر العهد بك، لكنا نجد أثر هذه المعرفة العميقة عند عبدالملك يظهر في تعريبه للدولة الأموية بشكل كامل – تقديس للغة والهوية – لولا كمية الإنفاق الذي أنفقه في هذا السبيل وسوء التقدير الذي وقع فيه وأنساه معارفه الأولى وروحه القديمة.
وعلى كل حال فالدولة الأموية لم تدم طويلاً، فقد تخللتها حروب ونزعات انفصالية وحركات تحرر كثيرة ومتتالية لم تترك لها مجالاً لصبغ المجتمع العربي والإسلامي بصبغة ثقافية معينة ولعل هذا من رحمة الله ولطفه، ففي كثير من الدراسات التاريخية نجد الروح العامة في ذلك الزمن كانت عنصرية لأبعد حد وهذا ما انعكس سلباً على حضارة عملاقة لم يُقدَّر لها أن تدوم.